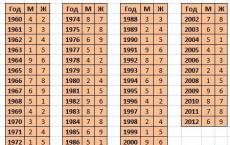الصراع الدولي: أنواعه وأنواعه وخصائصه. الصراعات الدولية
الصراع الدولي هو أحد أنواع الصراعات السياسية. النزاعات السياسية ناتجة عن عدم تطابق المصالح أو القيم أو تعريفات الموضوعات السياسية ، على التوالي ، يتم التمييز بين تضارب المصالح وتضارب القيم وتضارب التعريف الذاتي. وفقًا للمفهوم الأكثر شيوعًا ، يمكن تعريف النزاع الدولي على أنه صدام سياسي مفتوح بين دولتين أو أكثر (أو جهات فاعلة دولية أخرى) على أساس تناقض أو تضارب في مصالحها. قد تتعارض مصالح الدول بسبب الانتماء إلى إقليم معين ، بسبب مرور خط حدود الدولة. قد تكون المصالح ذات طبيعة اقتصادية مرتبطة بالوصول إلى استخدام أي موارد أو السيطرة عليها. يمارس علاقات دوليةيعرف أنواعًا وأنواعًا مختلفة من النزاعات الدولية. في أغلب الأحيان في تصنيفات النزاعات الدولية هناك تقسيمها إلى متماثل وغير متماثل. النزاعات المتماثلة هي تلك التي تتميز بقوة متساوية تقريبًا بين الأطراف المشاركة فيها. الصراعات غير المتكافئة هي صراعات مع اختلاف حاد في إمكانات الأطراف المتصارعة. الصراع الدولي هو أساس العلاقات الدولية في الجغرافيا السياسية التقليدية. هناك صراعات عسكرية سياسية واقتصادية ووطنية وحضارية ومذهبية وغيرها.
في العالم الحديثيتزايد خطر النزاعات المحتملة بسبب الزيادة في عدد وتنوع المشاركين في العلاقات الدولية. يُعتبر النزاع الدولي بمثابة علاقة سياسية خاصة بين طرفين أو أكثر - شعوب أو دول أو مجموعة دول - التي تتكاثر بشكل مكثف في شكل تصادم غير مباشر أو مباشر ، سواء كان اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو سياسيًا أو إقليميًا أو قوميًا أو دينيًا أو اهتمامات أخرى في الطبيعة والشخصية. ينشأ النزاع الدولي في أي حال عندما تسعى دولة أو مجموعة من الدول إلى فرض مصالحها على الآخرين ، وتعلن عن احتكارها وتحققه ، وتتعدى على مصالح أخرى أو لا تأخذها بعين الاعتبار على الإطلاق. وبالتالي ، فإن النزاعات الدولية هي نوع من العلاقات الدولية التي تدخل فيها دول مختلفة على أساس المصالح المتضاربة. الفاعلون في الصراع الدولي: وتشمل هذه تحالفات الدول والدول الفردية ، وكذلك الأحزاب والمنظمات والحركات التي تقاتل لمنع وإنهاء وحل أنواع مختلفةالنزاعات المتعلقة بممارسة السلطة.
السمة ، السمة الرئيسية لموضوعات الصراع ، حتى وقت قريب ، هي القوة. يُفهم على أنه قدرة أحد أطراف النزاع على إجبار أو إقناع موضوع آخر للنزاع بفعل شيء لا يفعله في موقف آخر. لا يقتصر مفهوم سلطة الدولة على مفهومها القوة العسكرية. ربما كان G.Morgenthau أول من أعطى وصفا شاملا للقوة. وأشار إلى تسعة عوامل في هذا المفهوم: الموقع الجغرافي؛ موارد طبيعية؛ الفرص الصناعية؛ الإمكانات العسكرية ، طابع وطني، والأخلاق الوطنية ، ودرجة دعم السكان ؛ جودة الدبلوماسية. الجودة الحكومية. السمة الثانية لموضوع الصراع هي موقفه. يشير هذا إلى موقع موضوع الصراع في النظام العام للعلاقات. إن الدور الكبير في النزاعات (المباشرة أو غير المباشرة) هو دعم رعايا النزاع من رعايا العلاقات الدولية الآخرين ، وكذلك شروط تحقيق إمكانات موضوعات النزاع. موضوع الصراع: يشير إلى المصلحة المتنازع عليها من قبل موضوعات النزاع ، معبراً عنها في حقهم المبرر أو الزائف في شيء ما. علاقات الصراع. بطبيعتها ، العلاقة بين الفاعلين السياسيينتنقسم إلى تحالف ، شراكة ، مواجهة ومعادية. يتميز الصراع بعلاقة المواجهة والعداء. نظرًا لأن الموضوع الرئيسي للنزاعات الدولية هو الدول ، يتم تمييز الأنواع التالية من النزاعات الدولية:
- 1. النزاعات بين الدول (يتم تمثيل كلا الجانبين المتعارضين من قبل الدول أو تحالفاتها) ؛
- 2. حروب التحرير الوطني (أحد الأطراف تمثله الدولة): مناهضة الاستعمار ، حروب الشعوب ، ضد العنصرية ، وكذلك ضد الحكومات التي تتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
- 3. النزاعات الداخلية المدولة (تعمل الدولة كمساعد لأحد الأطراف في نزاع داخلي على أراضي دولة أخرى).
بناءً على المصالح التي يتم الدفاع عنها في النزاع ، يتم تمييز النزاعات الدولية التالية:
- 1. صراع الأيديولوجيات (بين الدول ذات النظم الاجتماعية والسياسية المختلفة) ؛
- 2. النزاعات بين الدول لغرض الهيمنة السياسية في العالم أو منطقة معينة.
- 3. النزاعات التي يدافع فيها الطرفان عن المصالح الاقتصادية.
- 4. النزاعات الإقليمية على أساس التناقضات الإقليمية (الاستيلاء على الأراضي الأجنبية أو تحرير الأراضي الخاصة) ؛
- 5. النزاعات الدينية. يعرف التاريخ أمثلة كثيرة للصراعات بين الدول على هذا الأساس.
يمكن أن تختلف النزاعات الدولية أيضًا في نطاقها المكاني والزمني. في هذه الحالة ، يمكن تمييز الصراعات العالمية التي تؤثر على مصالح جميع المشاركين في العلاقات الدولية ؛ إقليمي ، محلي ، يضم عددا محدودا من المشاركين كأطراف في الصراع ، ثنائي. اعتمادًا على المدة ، يمكن أن تكون النزاعات الدولية طويلة الأمد أو متوسطة أو قصيرة المدى. اعتمادًا على الوسائل المستخدمة ، عادة ما يتم التمييز بين النزاعات الدولية المسلحة والنزاعات التي تستخدم الوسائل السلمية فقط. لقد أعطى العلم التعريف التالي للصراع: "الصراع - المواجهة - المعارضة - صراع المؤشر - عكس الأهداف أو المصالح أو الدوافع أو المواقف أو الآراء أو النوايا أو المعايير أو مفاهيم الموضوعات - المعارضون في عملية الاتصال - التواصل" اليوم ، مشكلة الصراع يتم التعامل معها من خلال أكثر من مجال من مجالات المعرفة العلمية. وهذا يشمل علم الاجتماع والتاريخ وعلم التربية والعلوم العسكرية والفلسفة وبالطبع علم النفس. تعتبر كل منطقة الصراع من وجهة نظرها الخاصة ، وبالتالي هناك أنواع عديدة من المفاهيم: الصراع الدولي ، الإقليمي ، العرقي ، العسكري ، التربوي ، الصراع في الفريق ، الاجتماعي ، العمل ، الصراع بين الزوجين ، صراع الآباء والأطفال ، الخ. الصراعات السياسية الدولية لا تنفصل عن العلاقات الدولية مثل العلاقات الدولية من تاريخ البشرية. إذا كان بإمكانهم الوجود بدون بعضهم البعض ، فذلك لفترة طويلة جدًا وليس لفترة طويلة. ومع ذلك ، فإن الصراع السياسي الدولي ، الذي تكرر منذ آلاف السنين على أسس حضارية واجتماعية وجيوسياسية مختلفة ، لم تتم دراسته بالكامل بعد. ليس الموقف المنهجي فحسب ، بل الموقف السياسي للباحثين يجبرهم أيضًا على تقديم إجابات مختلفة لأسئلة تبدو أبسط. وهكذا ، يلاحظ العلماء في مجال العلاقات الدولية أن "مفهوم" الصراع "يستخدم فيما يتعلق بالحالات التي تكون فيها مجموعة من الناس (قبلي أو إثني أو لغوي أو أي مجموعة أخرى) في معارضة واعية لمجموعة أخرى (أو غيرها). المجموعات) ، لأن كل هذه المجموعات تسعى إلى تحقيق أهداف غير متوافقة "
وبناءً على ذلك ، فإن مفهوم "النزاع الدولي" مشتق إما من التفاعل الاجتماعيتتكشف في ظروف تاريخية ملموسة أو من حالة نفسية في مجموعات. في هذا الاتجاه ، يحاول العلماء المقارنة ، وإذا أمكن ، الجمع بين بعض التعريفات الأكثر نجاحًا. من المهم التأكيد على أن مفهوم "القوة" يحظى بمكانة مركزية.
في الدراسات المحلية للنزاع الدولي ودوره ومكانته في نظام العلاقات الدولية ، على مدى العقود القليلة الماضية ، تم التأكيد على طبيعته السياسية بشكل ثابت. علاوة على ذلك ، تم تعريف أي نزاع دولي على أنه "الموقف السياسي لطرفين أو أكثر ، يتكاثر في شكل حادالتناقضات الأساسية للمشاركين فيها.
هناك ثلاثة مناهج رئيسية ، أو بعبارة أخرى ، ثلاثة اتجاهات رئيسية في دراسة النزاعات الدولية: "الدراسات الاستراتيجية" ، "دراسات الصراع" ، "دراسات السلام". الشيء الرئيسي الذي يوحدهم هو الرغبة في فهم دور هذه الظاهرة الاجتماعية في عمل النظام الدولي ، في العلاقة بين مكوناته المختلفة ، وصياغة استنتاجات على هذا الأساس قيمة عملية. في الوقت نفسه ، هناك اختلافات بينهما فيما يتعلق الأسس المنهجيةوقضايا المحتوى البحثية ، وطبيعة ارتباطها بممارسة العلاقات الدولية ، إلخ. عرّف العالم الأمريكي الشهير ل. أوزير الصراع الاجتماعي بأنه "صدام بين الفاعلين الجمعيين حول القيم أو المكانة أو القوة أو الموارد النادرة ، حيث تكون أهداف كل جانب هي تحييد خصومهم أو إضعافهم أو القضاء عليهم". بالاتفاق مع هذا الفهم ، ينطلق جزء واحد من الباحثين في العلاقات الدولية من حقيقة أن الصراع له محتوى موضوعي. لذلك ، من وجهة نظر ك. يأخذ." بعبارة أخرى ، نحن نتحدث عن معارضة المصالح ، التي يستحيل تنفيذها المتزامن من قبل المشاركين في التفاعل الدولي بسبب موضوعيتهم على وجه التحديد.
على العكس من ذلك ، من وجهة نظر جيه بيرتون ، "الصراع شخصي في الغالب ... الصراع الذي يبدو أنه ينطوي على اختلافات" موضوعية "في المصالح يمكن أن يتحول إلى صراع يكون له نتيجة إيجابية لكلا الجانبين ، شريطة أن "يعيدوا التفكير" في تصورهم لبعضهم البعض ، مما سيسمح لهم بالتعاون على أساس وظيفي لتقاسم مورد متنازع عليه "
المهمة المركزية البحث الاستراتيجيتتمثل في محاولة تحديد السلوك الأكثر ملاءمة للدولة في حالة النزاع ، والقادر على التأثير على العدو ، والسيطرة عليه ، وفرض إرادته. مع ظهور الأسلحة النووية ، يواجه المتخصصون في مجال مثل هذه الأبحاث عددًا من الأسئلة الجديدة بشكل أساسي ، وقد أعطى البحث عن إجابات لها دفعة جديدة للفكر الاستراتيجي.
إن إحدى المشكلات ذات الأولوية للبحث الاستراتيجي هي مشكلة الحرب وأسبابها وعواقبها بالنسبة لدولة معينة ومنطقة معينة والنظام الدولي (بين الدول) ككل. في الوقت نفسه ، إذا تم اعتبار الحرب السابقة ، وإن كانت وسيلة متطرفة ، ولكنها لا تزال "طبيعية" لتحقيق أهداف سياسية ، فإن القوة التدميرية الهائلة للأسلحة النووية أدت إلى تناقض ، من وجهة نظر النهج التقليدية ، الموقف. فمن ناحية ، تحصل الدولة التي تمتلكها على فرص جديدة لإدارة سياستها الخارجية والقدرة على ضمان سياستها الخاصة الأمن القومي(بالمعنى العسكري لهذا المفهوم). من ناحية أخرى ، فائض القوة الذي يعطي السلاح النووي، يجعل أي أفكار سخيفة حول تطبيقه ، حول احتمال حدوث صدام مباشر بين أصحابها.
نهاية الحرب الباردة الاتحاد السوفياتيوانهيار الهيكل الثنائي القطب للنظام الدولي العالمي يمثل بداية مرحلة جديدة في تطوير "استراتيجية كبرى". يجري طرح مهام الاستجابة المناسبة للتحديات التي يمليها انتشار أنواع جديدة من النزاعات في العالم الناتجة عن نمو العنف السياسي اللامركزي ، والقومية العدوانية ، والجريمة المنظمة الدولية ، وما إلى ذلك. علاوة على ذلك ، فإن تعقد هذه المهام ، والتي لها أهمية خاصة في سياق زيادة إمكانية الوصول أحدث الأنواعأسلحة الدمار الشامل ذات الطبيعة النووية و "التقليدية" على حد سواء ، تقلل من إمكانية حلها بطريقة البحث الاستراتيجي مع وجهة نظر "الجندي" التقليدية بالنسبة لها ، في محاولة لاختيار أفضل سلوك في مواجهة العدو ، وعدم طرح أسئلة حول الأسباب والأهداف النهائية للنزاعات ". يتم الحصول على هذا من خلال مناهج أخرى ، ولا سيما تلك التي تجد التطبيق في إطار مثل هذا الاتجاه مثل "دراسات الصراع".
ومن الأمور المركزية في هذا الاتجاه بالتحديد تلك الأسئلة التي لم تُطرح في إطار "البحث الاستراتيجي" - أي الأسئلة المتعلقة في المقام الأول بتوضيح أصل النزاعات الدولية وأنواعها. ومع ذلك ، هناك اختلافات لكل منهم.
وبالتالي ، يمكن إفراد موقفين بشأن مسألة منشأ النزاعات الدولية. في أحدها ، يتم تفسير النزاعات الدولية بأسباب تتعلق بطبيعة هيكل النظام الدولي. يميل أنصار الثاني إلى إخراجهم من السياق ، أي البيئة الداخليةأنظمة العلاقات بين الدول.
ج. جالتونج ، على سبيل المثال ، الذي اقترح " النظرية البنيويةالعدوان "، يعتبر سبب النزاعات الدولية عدم توازن في معايير الحكم على المكان الذي تحتله دولة معينة في النظام الدولي ، عندما يكون مكانتها العالية في هذا النظام ، وفقًا لبعض المعايير ، مصحوبة بنقص أو موقف منخفض بشكل غير متناسب من أي ناحية أخرى.
يقول غالتونغ: "إن ظهور العدوان يكون على الأرجح في حالة من عدم التوازن الهيكلي". وينطبق هذا أيضًا على النظام الدولي العالمي مع "الاضطهاد الهيكلي" الذي لوحظ في إطاره ، عندما تعمل الدول الصناعية ، بحكم سمات أداء نوع اقتصادها المتأصل ، كاضطهِدين ومستغِلين للبلدان المتخلفة. ومع ذلك ، فإن وجود خلل بنيوي لا يعني في حد ذاته أن النزاعات الناشئة عنه ستصل بالضرورة إلى حدها أعلى درجة- مواجهة عسكرية. يصبح الأخير هو الأكثر احتمالا في ظل شرطين: أولاًعندما يصبح العنف سمة متكاملة واعتيادية للمجتمع ؛ ثانياً ، عند استنفاد جميع الوسائل الأخرى لاستعادة التوازن المضطرب.
نوع آخر من المقاربة "الهيكلية" لمسألة أصل نزاع دولي هو الرغبة في الجمع بين تحليل المستويات الثلاثة التي اقترحها ك. والتز - الفرد والدولة والنظام الدولي. في المستوى الأول ، تتضمن دراسة أسباب الصراع الدولي دراسة الطبيعة الطبيعية للإنسان وعلم النفس - في المقام الأول سمات المظهر النفسي. رجال الدولة(ينعكس ، على سبيل المثال ، في نظريات الغرائز ، والإحباط ، والعدوان ، وما إلى ذلك). أما الثاني فيتناول المحددات والعوامل المرتبطة بالموقع الجيوسياسي للدول ، فضلًا عن خصوصيات الأنظمة السياسية والهياكل الاجتماعية والاقتصادية التي تهيمن عليها. يمكن أن تشمل الأفكار الهيكلية حول أصل النزاعات الدولية أيضًا الآراء التي سادت في الأدب السوفييتي حول طابعها وطبيعتها. تم تفسير أصل النزاعات من خلال عدم تجانس النظام الدولي العالمي بتقسيمه المتأصل إلى النظام الرأسمالي العالمي والاشتراكية العالمية و الدول الناميةومن بينها عمليات ترسيم الحدود على أساس طبقي. نشأت أسباب النزاعات ، مصدرها الرئيسي ، من الطبيعة العدوانية للإمبريالية.
من حيث الجوهر ، في إطار هذا الاتجاه ، نتحدث عن مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالبحث عن تسوية للنزاعات الدولية. عند دراسة النزاعات الدولية الحديثة وطرق حلها ، من الضروري مراعاة العمليات التي تجري في العالم الحديث. إحدى هذه العمليات هي العولمة ، التي لها بلا شك تأثير كبير على النزاعات الدولية وطبيعتها. كما Dovzhenko M.V. بعد النظر في عملية العولمة ، يمكن تحديد العديد من الاتجاهات العالمية "التي تؤثر بشكل مباشر على خصوصيات النزاعات الدولية الحديثة" أولاً ، يمكن أن يسمى أحد هذه الاتجاهات عدم وضوح الحدود بين الداخلية و السياسة الخارجية. فيما يتعلق بالنزاع ، قد يعني هذا أن الحدود بين النزاعات الداخلية والدولية غير واضحة إلى حد كبير اليوم.
يمكن تسمية أسباب ذلك بحقيقة أن الصراع في العالم الحديث ، الذي نشأ كصراع داخلي ، يصبح دوليًا نتيجة لتوسعه. يتصل به المشاركون الآخرون ويتجاوزون الحدود الوطنية. ولكن حتى لو لم يتم الوصول إلى ذلك ، فإن الصراع الداخلي يؤثر عادة على الدول المجاورة ، بما في ذلك نتيجة عبور اللاجئين للحدود. في حالات أخرى ، قد يكتسب النزاع الداخلي ، مع بقاءه داخليًا بشكل أساسي ، صبغة دولية بسبب مشاركة ممثلي البلدان الأخرى فيه. بالإضافة إلى ذلك ، تتحول بعض النزاعات الداخلية إلى صراعات دولية نتيجة وجود القوات الأجنبية في بلد الصراع ، وتدخلها المباشر في كثير من الأحيان. بالإضافة إلى ذلك ، في السنوات الأخيرة ، شارك وسطاء من دول ثالثة وممثلون عن المنظمات الدولية بشكل متزايد في عملية حل النزاعات الداخلية ، مما يضفي أيضًا على النزاعات الداخلية بُعدًا دوليًا.
ثانيًا ، يمكن تسمية إضفاء الديمقراطية على كل من العلاقات الدولية والعمليات السياسية المحلية على أنها اتجاه سياسي عالمي آخر. يمكن التعبير عن تأثير هذا الاتجاه على خصوصيات النزاعات الحديثة في حقيقة أن هناك اليوم عددًا من البلدان ذات أشكال برلمانية للحكم لم يتم فيها حل المشكلات بين الأعراق والأقاليم فحسب ، بل لوحظ أيضًا تحقيقها. بمعنى آخر ، يتم إنشاء وضع لا تستطيع فيه جميع الدول التي تأثرت بهذا الاتجاه اليوم حل مشكلة الحاجة إلى تحقيق الوحدة الوطنية (بما في ذلك قضية الحدود الإقليمية) والهوية الوطنية من خلال التفاوض (أي الديمقراطية). ) وسائل. وكما يشير دوفجينكو ، في مثل هذه الحالات "ينبغي إيلاء اهتمام خاص لمشكلة الحاجة إلى تحقيق الوحدة الوطنية (بما في ذلك مسألة الحدود الإقليمية) والهوية الوطنية كشرط مسبق لإرساء الديمقراطية. من الواضح أن هذه العملية صعبة للغاية ، لذلك ، في الواقع ، غالبًا ما نصبح شهودًا على صعود القومية ونشاط الحركات القومية بسبب وجود اختلافات وتناقضات وطنية حادة في البلاد. مناطق مختلفةسلام"
يرتبط اتجاه الدمقرطة اليوم أيضًا بظاهرة مثل التطور العالمي ونشر أحدث أنظمة الاتصال الجماهيري ، والأهم من ذلك ، إمكانية الوصول إليها لأي مواطن في مجتمع ديمقراطي حديث. يؤدي هذا إلى حقيقة أن العلاقات الدولية والسياسة الخارجية لم تعد ملكًا لمجموعة ضيقة من إدارات الدولة الخاصة ، بل أصبحت ملكًا لمجموعة متنوعة من المؤسسات الحكومية والمستقلة ، السياسية وغير السياسية.
نتيجة لذلك ، تتسع دائرة المشاركين المباشرين في العلاقات السياسية الحديثة بشكل ملحوظ اليوم. وغالبًا ما يُنظر إلى هذا على أنه اتجاه سياسي عالمي آخر. أصبح العدد المتزايد من المشاركين في العلاقات الدولية "مصدرًا للصدفة المطلقة في هذا المجال". ما يُلاحظ في العلاقات الدولية اليوم هو الانتقال من حالة الخطر ، التي كانت سمة فترة الحرب الباردة ، إلى حالة الشك. نظرًا لأنه غالبًا ما يكون سلوك الفاعلين الجدد (مثل الحركات الدينية والشركات عبر الوطنية والجمعيات السياسية) التي يمكنها التأثير بشكل مباشر على مسار الأحداث دون اعتبار للحكومات الوطنية أمرًا لا يمكن التنبؤ به وغير واضح دائمًا. نتيجة لذلك ، يوجد الآن قدر كبير من عدم اليقين في نظام MO ، ناتج عن مجموعة واسعة للغاية من المصالح والتطلعات والأهداف.
تكشف هذه المشاركة النشطة للجهات الفاعلة غير الحكومية في النزاعات الحديثة عن سمة أخرى لها. تثير هذه النزاعات صعوبات خاصة في حلها بالوسائل الدبلوماسية التقليدية ، والتي تشمل المفاوضات الرسمية وإجراءات الوساطة.
تعرف ممارسة العلاقات الدولية أنواعًا وأنواعًا مختلفة من النزاعات الدولية. العلوم السياسية تدرسها بنشاط. ومع ذلك ، لا يوجد تصنيف واحد للنزاعات الدولية معترف به من قبل جميع الباحثين. في أغلب الأحيان في تصنيفات النزاعات الدولية هناك تقسيمها إلى متماثل وغير متماثل. النزاعات المتماثلة هي تلك التي تتميز بقوة متساوية تقريبًا بين الأطراف المشاركة فيها. الصراعات غير المتكافئة هي صراعات مع اختلاف حاد في إمكانات الأطراف المتصارعة. التمييز بين الصراعات المتماثلة وغير المتكافئة مهم من وجهة نظر عملية. إذا دخل النزاع في مرحلة الكفاح المسلح ، فإن مدته ، والنتيجة النهائية ، في كثير من النواحي ، ستعتمد على نسبة إمكانات الأطراف المشاركة في النزاع.
يمكن توضيح ذلك من خلال مثال الوضع الذي تطور حول العراق في العقد الماضي. في السبعينيات. القرن ال 20 تمكن نظام صدام حسين ، بفضل عائدات النفط وصادراته ، من خلق إمكانات عسكرية كبيرة. س. حسين نفسه تصور نفسه "ستالين الشرق الأوسط" وسعى إلى أن يظهر للعالم كله قوة بلاده وجيشه. وكما بدا للزعيم العراقي ، فقد سنحت هذه الفرصة بعد انتصار "الثورة الإسلامية" في إيران عام 1979. كان هناك نزاع إقليمي طويل الأمد بين إيران والعراق على خط الحدود عند مصب نهر شطل العال. - نهر العرب. وغذى هذا الخلاف وجود احتياطيات نفطية كبيرة في هذه المنطقة. في عام 1975 ، تم توقيع معاهدة حدودية بين حكومة الشاه في إيران والسلطات العراقية ، والتي من المفترض أنها أزالت جميع القضايا الخلافية. ولكن عندما بدأت فترة الفوضى وعدم الاستقرار في إيران بعد الإطاحة بالشاه ، قرر صدام حسين استغلال الوضع والاستيلاء على المناطق الحدودية الإيرانية.
أطلق العنان للحرب ضد إيران ، أخذ الحسين بعين الاعتبار درجة عدم التنظيم وانهيار الجيش الإيراني ، لكنه لم يأخذ في الاعتبار حقيقة أن إمكانات الأطراف المتحاربة كانت متشابهة بشكل عام. اشتبك هذا الصراع المتماثل بين دولتين شرق أوسطيتين متوسطتي الحجم والسكان ، ولديهما احتياطيات نفطية كبيرة ودخل كبير من صادراتها. لم يكن لدى أي من الطرفين ميزة واضحة على الآخر ، لذا كان الانتصار الكامل لأي من المشاركين في هذا الصراع مستحيلاً. لذلك في النهاية حدث ذلك. وبعد ما يقرب من عشر سنوات من الأعمال العدائية ، قتل خلالها الطرفان مليون قتيل ، عاد العراق وإيران إلى اتفاقية 1975. الكويت ، خاصة وأن الجانب العراقي اعتبر الكويت على الدوام أرضًا منتزعة بشكل غير قانوني من العراق.
في هذه الحالة ، كان النزاع المسلح غير متكافئ ، لأن حجم الأطراف وإمكاناتهم العسكرية كانت غير قابلة للقياس. احتل الجيش العراقي أراضي الكويت ليوم واحد وأعلنت محافظة عراقية. لم يأخذ حسين في الاعتبار سوى إمكانات المشاركين المباشرين في الصراع ، ولم يأخذ بعين الاعتبار الوضع العام في العلاقات الدولية ككل. دفعت تصرفات العراق إلى إنشاء تحالف واسع مناهض للعراق بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. وقد فوض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا التحالف باستخدام القوة لإنهاء الاحتلال العراقي للكويت. مرة أخرى ، اتخذ هيكل الصراع طابعا غير متكافئ ، لكنه لم يعد في صالح العراق. تجاهلت القيادة العراقية هذا الظرف. كانت نتيجة عملية عاصفة الصحراء في أوائل عام 1990 هزيمة الجيش العراقي الذي أجبر على الانسحاب من الكويت. صمد نظام صدام في ذلك الوقت ، لكنه تعرض لعقوبات دولية. ومع ذلك ، الدروس المستفادة من الاشتباكات المسلحة 1989-1990. لم تعلم القيادة العراقية: من خلال أفعالها غير المتسقة والمتناقضة ، خلق نظام صدام حسين نفسه الظروف لغزو القوات المسلحة الأمريكية دون الحصول على الموافقة المناسبة من مجلس الأمن الدولي. لكن هذه المرة أخطأت إدارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش الابن في الحسابات. قيم الأمريكيون بشكل صحيح الصراع القادم بأنه غير متكافئ ، حيث سيكون للولايات المتحدة ميزة. هذا ما حدث خلال العملية العسكرية. لم يبد الجيش العراقي الضعيف مقاومة جدية ، وسرعان ما انهار نظام صدام حسين على خلفية الهزيمة العسكرية. ومع ذلك ، الآن في واشنطن لم يأخذوا في الحسبان حقيقة أنه في سياسة العالم الحديث ، لا يفصل "الجدار الصيني" المجالات السياسية الدولية والمحلية عن بعضها البعض ، بل ترتبط ارتباطًا وثيقًا ببعضها البعض. بداية عملية عسكريةضد نظام صدام حسين ، كانت القيادة الأمريكية تأمل أن تتمكن بعد الانتصار العسكري من قيادة العراق بسرعة إلى الديمقراطية والازدهار ، وإرساء أسس "دمقرطة الشرق الأوسط الكبير". ومع ذلك ، تبين أن الوضع الحقيقي مختلف. أثار الوجود العسكري الأجنبي في العراق مقاومة مسلحة.
بالإضافة إلى ذلك ، أصبح العراق ، الذي مزقته الصراعات العرقية والدينية الداخلية ، بؤرة للإرهاب. لقد أدت سياسة غير مدروسة بسلطات واشنطن إلى وضع لا يمكن أن يكون هناك مخرج بسيط وسهل.
بالنسبة لتصنيف النزاعات الدولية ، يمكن للمرء استخدام تصنيف النزاعات السياسية الذي اقترحه أ. رابابورت ، والمعايير الخاصة به هي خصائص عملية الصراع ودوافع سلوك المشاركين فيه. بناءً على هذه المعايير ، يحدد رابابورت نماذج الصراع هذه: معركة ، نقاش ، نزاع.
أخطرها على السلام والأمن هو الصراع الذي يتطور على شكل "معركة". يشير اسمها ذاته إلى أن الأطراف المتورطة في النزاع هي في البداية متحاربة تجاه بعضها البعض وتسعى جاهدة لإلحاق أكبر قدر من الضرر بالعدو ، بغض النظر عن العواقب المحتملة على نفسها. يمكن تعريف سلوك المشاركين في مثل هذا الصراع على أنه سلوك غير عقلاني ، لأنهم غالبًا ما يضعون لأنفسهم أهدافًا غير قابلة للتحقيق ، ولا يدركون بشكل كافٍ الوضع الدولي وتصرفات الجانب الآخر.
على العكس من ذلك ، في نزاع يتجلى في شكل "لعبة" ، يتم تحديد سلوك المشاركين من خلال اعتبارات عقلانية. على الرغم من المظاهر الخارجية للقتال ، لا يميل الطرفان إلى تفاقم العلاقات إلى أقصى الحدود. يتم اتخاذ القرارات على أساس مراعاة جميع العوامل والظروف ، بناءً على تقييم موضوعي للوضع.
بالنسبة للنزاع الذي يتطور إلى "نقاش" ، فإن رغبة المشاركين في حل التناقضات التي نشأت من خلال التوصل إلى حلول وسط هي رغبة متأصلة في حد ذاتها. "النقاش" هو حالة من الصراع عندما تنفتح الآفاق لإيجاد حل وسط مقبول لجميع الأطراف. أفضل طريقة للخروج من حالة الصراع هي الانتقال من "معركة" من خلال "لعبة" إلى "مناقشة". لكن المسار المعاكس ممكن أيضًا: من "المناظرة" إلى "اللعبة" من أجل تحقيق التنازلات ، ومن "اللعبة" الانتقال بشكل غير محسوس إلى "معركة" حقيقية ، مما يستبعد إمكانية الوصول إلى حلول وسط.
هذا التصنيف مهم أيضًا للأنشطة العملية للتسوية السلمية للنزاعات الدولية.
في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي ، عندما بدأ استخدام الأساليب والأساليب الرياضية بنشاط كبير في البحث الإنساني ، تم استعارة تقسيم الصراعات إلى صراعات مع مجموع صفري وغير صفري (موجب) من نظرية الألعاب الرياضية. ثم تمت إضافة تضارب مع مبلغ سلبي لهم.
الصراع الصفري هو صراع تتعارض فيه مصالح الطرفين تمامًا وانتصار أحدهما يعني هزيمة الآخر والعكس صحيح. التسوية غير ممكنة هنا. الصراع مع مبلغ إيجابي- هذا نزاع توجد فيه فرصة حقيقية لإيجاد حل مقبول للجميع. نتيجة للتسوية التي تم تحقيقها ، يتم إرضاء مصالح جميع المشاركين إلى حد ما. يتعارض مع مبلغ سلبي عواقب سلبيةتعال لجميع المشاركين فيها. مثال على مثل هذا الصراع في العلاقات الدولية هو الحرب النووية ، حيث ، كما تعلم ، لا يوجد فائزون.
من حيث عدد المشاركين ، يمكن تقسيم النزاعات الدولية إلى ثنائية ومتعددة الأطراف.
ويستند تصنيف آخر للنزاعات الدولية إلى العامل المكاني والجغرافي ، أي أنه يأخذ في الاعتبار مستوى تغطية نظام العلاقات الدولية بالنزاع. ليس للنزاعات الدولية العالمية حدود مكانية ؛ فمصير جميع الدول تقريبًا وتوجهات واتجاهات التنمية العالمية تعتمد بدرجة أو بأخرى على نتائجها. أمثلة من الصراعات العالمية هي الحرب العالمية الأولى والثانية. كما تميزت الحرب الباردة بطابعها العالمي ، لأنها حددت اتجاهات تطور العلاقات الدولية لعدة عقود - من أواخر الأربعينيات إلى أواخر الثمانينيات. القرن ال 20
تؤثر النزاعات الإقليمية على العلاقات الدولية داخل نفس المنطقة السياسية والجغرافية. عدد المشاركين فيه محدود مقارنة بالصراعات العالمية ، والعواقب أقل شمولاً. تتطور النزاعات المحلية على المستوى دون الإقليمي أو المحلي. كقاعدة عامة ، فهي تتعلق بمشاكل ومناطق محددة. وتشمل هذه معظم النزاعات الداخلية الثنائية والمدولة على حد سواء. لأنه من الصعب في الممارسة العملية رسم خط بين المستويين الإقليمي ودون الإقليمي للعلاقات الدولية ، الإقليمي والمستوى الصراعات المحليةغالبًا ما يتم فصلهم إلى مجموعة عامة. وهذا أمر منطقي ، حيث من الواضح أنها تختلف في نطاقها وعواقبها عن الصراعات العالمية. في الظروف الحديثةعندما تكون إمكانية نشوب صراع دولي عالمي صغيرة للغاية ، فإن النزاعات الإقليمية والمحلية تمثل التهديد الرئيسي للسلم والأمن العالميين.
في أغلب الأحيان في تصنيفات النزاعات الدولية تقسيمهم إلى متماثل وغير متماثل :
صراعات متماثلةتتميز بقوة متساوية تقريبًا بين الأطراف المشاركة فيها. غير متماثل - هذه صراعات مع اختلاف حاد في إمكانات الأطراف المتصارعة. إذا دخل النزاع في مرحلة الكفاح المسلح ، فإن مدته ، والنتيجة النهائية ، في كثير من النواحي ، ستعتمد على نسبة إمكانات الأطراف المشاركة في النزاع.
لتصنيف النزاعات الدولية ، يمكن للمرء استخدام المقترح
أ. تصنيف رابابورت للصراعات السياسية
، المعايير التي من أجلها هي خصائص عملية الصراع ودوافع سلوك المشاركين فيها. بناءً على هذه المعايير ، يحدد Rappoport نماذج الصراع التالية: القتال والنقاش والنزاع
.
أخطرها على السلام والأمن هو الصراع الذي يتطور في الشكل "المعارك". الأطراف المتورطة في النزاع هم في البداية متحاربون تجاه بعضهم البعض ويسعون لإلحاق أكبر قدر من الضرر بالعدو ، بغض النظر عن العواقب المحتملة على أنفسهم. سلوك الأعضاء يمكن تعريف مثل هذا الصراع على أنه غير منطقي ، لأنهم غالبًا ما يضعون أنفسهم أهداف غير قابلة للتحقيق ، فهم غير كافٍ للوضع الدولي وأفعال الجانب الآخر.
على العكس من ذلك ، في الصراع الذي يتكشف في الشكل "ألعاب"، يتم تحديد سلوك المشاركين عاقِل الاعتبارات. على الرغم من مظاهر التشدد الخارجية ، لا تميل الأطراف إلى تفاقم العلاقات إلى أقصى الحدود. يتم اتخاذ القرارات على أساس مراعاة جميع العوامل والظروف ، بناءً على تقييم موضوعي للوضع.
للصراع النامية كما "مناظرة"، متأصلة في رغبة المشاركين في حل التناقضات التي نشأت بالتوصل إلى حلول وسط. أفضل طريقة للخروج من حالة الصراع هي الانتقال من "معركة" من خلال "لعبة" إلى "مناقشة". لكن المسار المعاكس ممكن أيضًا: من "المناظرة" إلى "اللعبة" من أجل تحقيق التنازلات ، ومن "اللعبة" الانتقال بشكل غير محسوس إلى "معركة" حقيقية ، مما يستبعد إمكانية الوصول إلى حلول وسط.
في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي ، تم استعارة تقسيم الصراعات من نظرية الألعاب الرياضية بالنسبة إلى التعارضات مع مجموع صفري وغير صفري (موجب). ثم أضيفت الصراعات إليهم بكمية سالبة.
الصراع الصفري- هذا صراع تتعارض فيه مصالح الطرفين تماما وانتصار أحدهما معناه هزيمة الآخر والعكس صحيح. التسوية غير ممكنة هنا.
صراع المجموع الإيجابي- هذا نزاع توجد فيه فرصة حقيقية لإيجاد حل مقبول للجميع. نتيجة للتسوية التي تم تحقيقها ، يتم إرضاء مصالح جميع المشاركين إلى حد ما.
في صراع المجموع السلبي تأتي العواقب السلبية لجميع المشاركين فيها. مثال على مثل هذا الصراع في العلاقات الدولية هو الحرب النووية ، حيث ، كما تعلم ، لا يوجد فائزون.
من وجهة نظر عدد المشاركين يمكن تقسيم النزاعات الدولية إلى الثنائية والمتعددة الأطراف.
يعتمد تصنيف آخر للنزاعات الدولية على العامل المكاني والجغرافي ، أي يأخذ في الاعتبار مستوى تغطية نظام العلاقات الدولية بالنزاع:
عالميليس للنزاعات الدولية حدود مكانية ؛ فمصير جميع الدول تقريبًا وتوجهات واتجاهات التنمية العالمية تعتمد بدرجة أو بأخرى على نتائجها. أمثلة على الصراعات العالمية - الحربين العالميتين الأولى والثانية . كانت عالمية بطبيعتها والحرب الباردة ، لأنها حددت اتجاهات تطور العلاقات الدولية لعدة عقود - من أواخر الأربعينيات إلى أواخر الثمانينيات. القرن ال 20
إقليميتؤثر النزاعات على العلاقات الدولية داخل نفس المنطقة الجغرافية السياسية. عدد المشاركين فيه محدود مقارنة بالصراعات العالمية ، والعواقب أقل شمولاً.
محليتتطور الصراعات على المستوى دون الإقليمي أو المحلي. كقاعدة عامة ، فهي تتعلق بمشاكل ومناطق محددة. في الظروف الحديثة ، عندما يكون احتمال نشوب صراع دولي عالمي ضئيل للغاية ، فإن النزاعات الإقليمية والمحلية هي التهديد الرئيسي للسلم والأمن العالميين.
الصراعات العرقية -تتماهى الأحزاب مع مجموعة عرقية أو دينية معينة وليس مع المجتمع ككل. مثال: عدم المساواة بين الدولة والقومية بين الشعوب ، وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية للمناطق ، والتعدي الثقافي واللغوي ، وخطر اختفاء الأقليات العرقية نتيجة للضرر بيئةأو تأثير "حضاري" طائش.
الصراعات الاقتصادية -هذه مواجهة بين موضوعات التفاعل الاجتماعي (الأمم ، الدول ، الطبقات ، إلخ) بناءً على المصالح الاقتصادية المتعارضة التي يحددها الموقع والدور في نظام العلاقات الاجتماعية (علاقات الملكية ، والسلطة ، والقانون ، وما إلى ذلك).
(بين الأديان) الصراع الديني -
هذا صدام ومعارضة بين أصحاب القيم الدينية (من الأفراد - المؤمنين
إلى الاعترافات) ، والتي ترجع إلى الاختلافات في نظرتهم للعالم ، وأفكارهم
والموقف من الله ، مشاركة مختلفة في الحياة الدينية.
وظائف الصراع:
إيجابي:
منع الركود في العلاقات الدولية ؛
تحفيز المبادئ الإبداعية بحثًا عن طرق للخروج منها المواقف الصعبة;
تحديد درجة عدم التوافق بين مصالح وأهداف الدول ؛
نزع فتيل التوتر بين الأطراف المتصارعة.
· منع الصراعات الكبيرة وضمان الاستقرار من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على الصراعات منخفضة الحدة.
يستلم معلومات جديدةعن الخصم
حشد الشعب في مواجهة عدو خارجي.
تحفيز التغيير والتنمية ؛
سلبي:
التكاليف المادية والعاطفية الكبيرة للمشاركة في الصراع ؛
تسبب الفوضى وعدم الاستقرار والعنف ؛
تدهور المناخ الاجتماعي والنفسي في البلاد والمنطقة ؛
· تمثيل الجماعات المهزومة كأعداء.
· بعد انتهاء النزاع - انخفاض في درجة التعاون بين مجموعات الشعوب.
· تؤدي إلى احتمال اتخاذ قرارات سياسية غير فعالة.
التعافي الصعب للعلاقات التجارية ("مسار النزاع").
© 2015-2019 الموقع
جميع الحقوق تنتمي إلى مؤلفيها. لا يدعي هذا الموقع حقوق التأليف ، ولكنه يوفر الاستخدام المجاني.
تاريخ إنشاء الصفحة: 2017-06-11
الصراع في العلاقات الدولية هو تفاعل بين كيانين أو أكثر يسعون لتحقيق أهداف متبادلة بمساعدة تدابير الإكراه المباشرة أو غير المباشرة.
أنواع النزاعاتتعتمد على الموقف الدولي لأطراف النزاع: قد تكون هناك صراعات داخلية بين الدول وداخلية مدولة. النزاعات (الدولية) ممكنة ، ويمكن أن تكون مسلحة وغير مسلحة ؛ ثنائية ومتعددة الأطراف ؛ على المدى القصير والطويل ؛ العالمية والإقليمية والمحلية ؛ إيديولوجي ، اقتصادي ، إقليمي ، ديني ، إلخ. اعتمادًا على تحقيق مصالح الأطراف ، يتم تمييز تضارب المحصل الصفري (عندما يتلقى أحد المشاركين نفس القدر الذي يخسره الآخر تمامًا) ؛ تضارب المحصلة الإيجابية (عندما يظل كلاهما فائزًا ، نظرًا لأنهما يسعيان للحصول على مزايا مختلفة نتيجة للنزاع) ؛ يتعارض مع مبلغ سلبي (عندما ، نتيجة للصراع ، لا يكسب كلا المشاركين شيئًا فحسب ، بل يخسرون أيضًا). من الممكن التمييز بين الصراعات المتماثلة وغير المتماثلة اعتمادًا على مقدار قوة المشاركين.
مصدريعتبر الصراع الدولي:
- 1) التغيير في ميزان القوى العالمية (اختلال التوازن العالمي) ؛
- 2) التغيير في ميزان القوى في المنطقة (اختلال التوازن الإقليمي) ؛
- 3) العمل الواعي لواحد أو آخر من الفاعلين في السياسة العالمية ، والذي يهدف إلى تحقيق مزايا أحادية طويلة الأجل من شأنها أن تخلق تهديدات حقيقية أو خيالية للمصالح الحيوية لموضوعات أخرى في العلاقات الدولية. تصرفات الموضوعات لها جانب موضوعي وذاتي.
موضوعي
- - الإهتمامات؛
- - وظيفة الدور والهيبة الدولية ؛
- - كتلة الالتزامات.
شخصيمكون من عمل الصراع:
- - الفهم الذاتي للمشاركين في الصراع ؛
- - المكون العاطفي (الصورة النفسية للطرف المقابل ؛ الرموز النموذجية) ؛
- - المكون المعرفي؛ المفاهيم الخاطئة.
عند وصف نزاع دولي ، يحدد الباحثون العناصر الهيكلية: مصدر النزاع ، موضوع النزاع ، أطراف النزاع. إيماءة موضوع الصراعفهم مختلف مالورأس المال الرمزي: الأرض ، والموارد الطبيعية والبشرية ، وأهداف الاقتصاد ، والسلطة ، والسلطة ، والهيبة ، وما إلى ذلك. يتجلى موضوع الصراع كهدف تسعى إليه الأطراف المتصارعة.
يحدث تعارض بين اثنين أو أكثر حفلات، وهي أساسية أو مباشرة المشاركين في الصراع.إلى جانب الأطراف الرئيسية ، هناك أيضًا مشاركون غير مباشرون لا يقومون بعمل مباشر في النزاع نفسه ، ولكن بطريقة أو بأخرى يربحون أحد الأطراف بالطرق السياسية والاقتصادية ، من خلال توفير المعدات العسكرية وغير العسكرية ، إلخ. صياغة مطالبة من قبل المشارك والمقترحات لحل المشكلة موقف المشارك.يمكن أن يكون الموقف صعبًا إذا تم تقديمه في شكل مطالب نهائية لا لبس فيها وإنذارات نهائية تسمح للطرف المقابل بعدم فعل شيء سوى الاتفاق معها. سيتم التعرف على الموقف ناعمما لم تستبعد التنازلات المقبولة للطرفين. يتم تفسير الاختلافات في مواقف الأطراف من خلال الاختلافات في مصالح الأطراف(شروط بقائها ووجودها) و المقاصد(تصورات حول الوضع الدولي المرغوب فيه للأطراف المقابلة). وهكذا ، وراء المظاهر الخارجية للصراع ، وكذلك وراء مواقف المشاركين فيها ، هناك تناقضات في مصالحهم وقيمهم.
الصراعات الدولية هي نتيجة الخلل الهيكلي (توازن القوى) في النظام الدولي. تقليديا ، هناك عدة مجموعات من النزاعات الدولية مميزة: ما يسمى ب كلاسيكيالصراعات (على سبيل المثال ، حروب التحرير الوطنية) ؛ الإقليمية(على سبيل المثال ، انفصال أو انضمام بعض الأقاليم) ؛ ^ الإقليمية(اجتماعية - اقتصادية ، أيديولوجية ، عرقية ، دينية ، إلخ).
تطور الصراع له تسلسل معين (مراحل الصراع).
الطور الأولالصراع الدولي هو موقف سياسي أساسي يتشكل على أساس بعض التناقضات الموضوعية والذاتية وما يقابلها من العلاقات الاقتصادية ، والأيديولوجية ، والقانونية الدولية ، والعسكرية الاستراتيجية ، والدبلوماسية فيما يتعلق بهذه التناقضات ، والتي يتم التعبير عنها في شكل صراع حاد إلى حد ما.
المرحلة الثانيةالصراع الدولي - التحديد الذاتي من قبل أطراف النزاع لمصالحهم وأهدافهم واستراتيجياتهم وأشكال نضالهم لحل التناقضات الموضوعية أو الذاتية ، مع مراعاة إمكاناتهم وإمكانياتهم لاستخدام الوسائل السلمية والعسكرية ، واستخدام التحالفات والالتزامات الدولية ، وتقييم الوضع العام الداخلي والدولي. في هذه المرحلة ، يحدد الطرفان أو ينفذان جزئيًا نظامًا من الإجراءات العملية المتبادلة التي هي في طبيعة النضال أو التعاون من أجل حل التناقض في مصلحة هذا الطرف أو ذاك أو على أساس حل وسط بينهما.
المرحلة الثالثةالصراع الدولي هو استخدام الأطراف (مع التعقيد اللاحق لنظام العلاقات السياسية وأفعال جميع المشاركين المباشرين وغير المباشرين في هذا الصراع) مجموعة واسعة إلى حد ما من الاقتصادية والسياسية والأيديولوجية والنفسية والأخلاقية والقانونية الدولية والدبلوماسية و حتى الوسائل العسكرية (دون استخدامها ، مع ذلك ، في شكل عنف مسلح مباشر). حولأيضًا حول المشاركة بشكل أو بآخر من الدول الأخرى من قبل الأطراف المتنازعة مباشرة (بشكل فردي ، من خلال التحالفات العسكرية السياسية ، والمعاهدات ، من خلال الأمم المتحدة). من الممكن تحديد سلسلة كاملة من الإجراءات التي تتطور باستمرار - "الضغط على الطرف المقابل" (الجدول 12.1).
الجدول 12.1
تصرفات الدول قبل بدء الصراع العسكري
|
اسم أجراءات |
|
|
المطالبات |
|
|
اتهامات |
|
|
|
|
إظهار القوة |
|
المرحلة الرابعةيرتبط الصراع الدولي بزيادة الصراع إلى المستوى السياسي الأكثر حدة - الأزمة السياسية الدولية. يمكن أن تغطي علاقات المشاركين المباشرين ، والدول في منطقة معينة ، وعدد من المناطق ، والقوى العالمية الكبرى ، وإشراك الأمم المتحدة ، وفي بعض الحالات تصبح أزمة عالمية ، مما سيعطي الصراع حدة غير مسبوقة واحتمال أن سيتم استخدام القوة من قبل طرف واحد أو أكثر.
المرحلة الخامسة -نزاع مسلح دولي يبدأ بنزاع محدود (تغطي القيود الأهداف والأراضي وحجم ومستوى الحرب والوسائل العسكرية المستخدمة وعدد الحلفاء ووضعهم العالمي). الأعمال العسكرية - الأعمال العنيفة للدول باستخدام القوات النظامية أو غير النظامية أو المرتزقة (المتطوعين):
- أ) الاستخدام المحدود للقوة (صراع محلي منخفض الشدة وعابر) ؛
- ب) صراع واسع النطاق - حرب- الأعمال العنيفة للدول باستخدام القوات النظامية ، مصحوبة بعواقب قانونية دولية لا رجعة فيها.
ثم ، في ظل ظروف معينة ، يتطور إلى مستوى أعلى من استخدام الكفاح المسلح أسلحة حديثةوالتورط المحتمل للحلفاء من جانب واحد أو كلا الجانبين. إذا أخذنا في الاعتبار هذه المرحلة من الصراع الدولي في الديناميكيات ، فيمكننا حينئذٍ التمييز بين عدد من المراحل الفرعية فيها ، مما يدل على تصاعد الأعمال العدائية. تصعيد الصراع -زيادة ثابتة في شدة الإجراءات الثنائية أو الأحادية للدول في الزمان والمكان. إنه يختلف: حسب الوسائل المستخدمة ، وعدد الموضوعات ، والمدة ، وتغطية الإقليم. يقلل التصعيد من حرية التصرف للمشاركين ، مما يجعلهم يختارون من بين خيارات أقل للسلوك. والنتيجة الأكثر خطورة أن الأطراف ستقع في "مصيدة التصعيد" ، أي. حالة لا يوجد فيها سوى إمكانية تصعيد النزاع.
المرحلة السادسةالصراع الدولي هو مرحلة من مراحل التسوية ، تنطوي على خفض تدريجي للتصعيد ، وانخفاض في مستوى الشدة ، وتكثيف الوسائل الدبلوماسية ، وتحديد الحلول الوسط الممكنة ، وتوضيح الموقف. في الوقت نفسه ، تبدأ تسوية النزاع من قبل أطراف النزاع أو تكون نتيجة لضغوط من جهات دولية أخرى: قوة عالمية ، منظمة عالميةأو المجتمع الدولي الذي تمثله الأمم المتحدة. كل هذا يتطلب موارد مادية وعسكرية ومعنوية.
في التنظيم والوقايةالصراعات الدولية تخصص الطرق التقليدية: المفاوضات ، والاستعانة بخدمات طرف ثالث ، وإنشاء لجان تحقيق ومصالحة ، وأساليب مؤسسية: بمساعدة المنظمات الحكومية الدولية ، بالطرق السلمية والقوة. الاتجاهات الرئيسية لمنع الصراعات بين الدول هي: تدويل نزاع تختمر من قبل المجتمع الدولي ؛ التحكيم الدولي؛ خفض مستوى المواجهة العسكرية (خفض التسلح) بفعل المنظمات الدولية الإقليمية.
هناك عدة خيارات مستعمرةالصراع: تخفيف الصراع (فقدان الحافز ، إعادة توجيه الدوافع ، استنفاد الموارد ، نقاط القوة والقدرات) ؛ القرار من خلال نشاط الطرفين (التعاون ، التسوية ، التنازلات) ؛ التسوية بمساعدة طرف ثالث ؛ التصعيد إلى صراع آخر ؛ انتصار احد الاحزاب. وبالتالي تخصيص الاستراتيجيات الرئيسيةمخرج من الصراع: التنافس (فرض قرار المرء) ؛ حل وسط (تنازلات جزئية) ؛ التعاون (مناقشة بناءة للمشكلة) ؛ التجنب (تجنب حل المشكلة) ؛ التكيف (الرفض الطوعي للقتال). بالمعنى الدقيق للكلمة ، فإن طرق الخروج من الصراع ضغط القوة(مباشر في شكل نزاع مسلح ، حرب ، إرهاب ، إلخ) و الهيكلي(التعدي على الاحتياجات البشرية الأساسية ، والحد من المعلومات ، وتدمير البنية التحتية الداعمة للحياة ، وما إلى ذلك) و تفاوض.المشكلة الرئيسية في حل النزاعات هي أن العديد من النزاعات ، في أحسن الأحوال ، لا تنجح إلا في ذلك يدير(أي خفض التصعيد) ، ولفترة. إذا كان من الممكن القضاء على أسباب الصراع ، فيمكننا التحدث عنها حل النزاع.
تفاوضطريقة غير عنيفة للتسوية / حل النزاع. يمكن أن تكون ثنائية ومتعددة الأطراف ، مباشرة وغير مباشرة (بمشاركة طرف ثالث). تم تحديد استراتيجيات التفاوض الرئيسية: الضغط الشديد ، عندما يريد كل جانب الفوز فقط ؛ تنازلات متبادلة - تنازلات محتملة ، مع مراعاة المواقف القوية والضعيفة للخصم ؛ مفاوضات مطولة وألعاب غير شريفة ، عندما يطول الطرفان المفاوضات لكسب الوقت والحصول على منفعة أحادية الجانب. مراحل المفاوضات الدولية: الاعتراف بوجود نزاع ؛ الموافقة على القواعد والمعايير الإجرائية ؛ تحديد القضايا الخلافية الرئيسية ؛ يذاكر خياراتحل المشكلة؛ البحث عن اتفاقيات حول كل قضية ؛ توثيق جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها ؛ الوفاء بجميع الالتزامات المتبادلة المقبولة.
الشكل الأكثر قبولًا لحل نزاع دولي هو تحقيق توازن مصالح أطرافه ، مما يجعل من الممكن القضاء على سبب الصراع في المستقبل. إذا تعذر تحقيق مثل هذا التوازن أو إذا تم التعدي على مصالح أحد الطرفين نتيجة لهزيمة عسكرية ، يصبح النزاع كامنًا وقادرًا على التكثيف في ظل ظروف محلية ودولية مواتية. في عملية حل النزاع ، من الضروري مراعاة البيئة الاجتماعية والثقافية لكل طرف ، وكذلك مستوى وطبيعة تطور نظام العلاقات الدولية.
في أي من المراحل الخمس الأولى التي تم النظر فيها من الصراع الدولي ، يمكن أن يبدأ مسار التنمية البديل ، وليس التصعيد ، ولكن المهدئ للتصعيد ، والذي يتجسد في الاتصالات الأولية وتعليق الأعمال العدائية ، والمفاوضات لإضعاف هذا الصراع أو الحد منه. مع مثل هذا التطور البديل ، يمكن أن يحدث إضعاف أو "تجميد" أو إزالة أزمة معينة أو حتى نزاع على أساس التوصل إلى حل وسط بين الأطراف حول التناقض الكامن وراء الصراع. ومع ذلك ، في هذه المرحلة من الممكن ، في ظل ظروف معينة ، و دورة جديدةالتطور التطوري أو المتفجر للنزاع ، على سبيل المثال ، من المرحلة السلمية إلى المرحلة المسلحة ، إذا لم يتم القضاء على التناقض المحدد الكامن وراءه بشكل كامل ولفترة طويلة بما فيه الكفاية. إن التطور المحتمل لنزاع دولي من الصعب للغاية ليس فقط حله ، ولكن أيضًا للتنبؤ به.
أسئلة ومهام لضبط النفس
- 1. اعرض مفهومك الخاص لمصطلح "النزاع الدولي".
- 2. اذكر مصادر الصراع الدولي.
- 3. قم بتسمية خيارات تصنيف النزاعات الدولية.
- 4. ما هي المكونات الموضوعية والذاتية للصراع؟
- 5. ما الذي يميز موضوع النزاع الدولي؟
- 6. تصور بشكل تخطيطي مراحل نشوء وتطور نزاع دولي.
- 7. ضع قائمة بأنواع (متغيرات) النزاعات المسلحة الدولية المعروفة لديك.
- 8. ما هو الاختلاف في مقاربات المدارس الرئيسية لنظرية العلاقات الدولية لتصنيف الحروب؟
- 9. ما المقصود بتسوية نزاع دولي؟
- 10. وضع قائمة بأساليب وأشكال تسوية النزاعات الدولية. أي منهم ستصنفه على أنه تقليدي وأي منها مبتكر؟
- انظر: Deriglazova L.V. صراعات غير متكافئة: معادلة بها العديد من الأشياء المجهولة. تومسك: دار النشر تومسك ، أون تا ، 2009. ص 5.
- انظر: أساسيات النظرية العامة للعلاقات الدولية: كتاب مدرسي ، دليل / محرر أ. S. مانيكينا. م: دار النشر بجامعة موسكو الحكومية ، 2009. س 458.
- هناك تصنيفات راسخة للحروب يستخدمها بشكل أساسي الماركسيون أو الواقعيون أو المثاليون السياسيون (الليبراليون). التصنيف الاكسيولوجي مستخدم على نطاق واسع. تستخدم الماركسية مفاهيم الحروب العادلة وغير العادلة. نسخته المصقولة متأصلة في الليبراليين الذين خصوا الحروب المشروعة - التي يبررها القانون الدولي ، والتي تشن بالوسائل التقليدية ضد القوات المسلحة لمعاقبة المعتدي ونزع سلاحه أو لحماية حقوق الإنسان ، وغير الشرعية - العدوانية أو العقابية. يميز الواقعيون: 1) ملائم سياسياً وليس ("متشنج" ، خارج السيطرة السياسية ومدفوعاً بدوافع غير عقلانية). 2) التدخلات وحروب عدم الاحتكاك. 3) المحلية والإقليمية والعالمية ؛ 4) أجريت بأسلحة غير فتاكة وبأسلحة تقليدية وصراع ABC.
- بالنظر إلى الموارد المادية والعسكرية والأخلاقية ، يمكن للقوة العالمية تنفيذ "إستراتيجية المشاركة" ، والتي تهدف إلى تحويل خصم مهزوم إلى شريك أو حليف. وهو يقوم على مبدأ "6R": الجبر ، إعادة الإعمار ، القصاص (القصاص) ، استعادة العدالة ، المصالحة (المصالحة) ، الحل (حل النزاع).
وفقًا لطبيعة التناقضات الكامنة وراء الصراع الدولي ، يتم التمييز بين التناقضات الاقتصادية والسياسية والعسكرية الاستراتيجية والجيوسياسية والأيديولوجية والاجتماعية السياسية والعرقية والدينية ، والتي يمكن تقسيمها بشكل مشروط إلى مجموعتين: سياسية وغير سياسية.
على النطاق المكاني والزماني. في هذه الحالة ، يمكن تمييز الصراعات العالمية التي تؤثر على مصالح جميع المشاركين في العلاقات الدولية ؛ إقليمي ، محلي ، يضم عددا محدودا من المشاركين كأطراف في الصراع ، ثنائي.
اعتمادًا على المدة ، يمكن أن تكون النزاعات الدولية طويلة الأمد أو متوسطة أو قصيرة المدى.
اعتمادًا على الوسائل المستخدمة ، عادة ما يتم التمييز بين النزاعات الدولية المسلحة والنزاعات التي تستخدم الوسائل السلمية فقط.
بحكم طبيعة التنمية ، يمكننا التمييز بين: الصراعات الدولية التطورية ، والتي يمر خلالها الصراع على التوالي بمراحل عديدة من التطور: متقطعة ، حيث يمكن القفز عبر مراحل التنمية نحو كل من تصعيد الصراع وتخفيفه ، خامل ومتفجر. كامن وصريح.
في النزاعات الدولية ، الجهات الفاعلة الرئيسية هي بالدرجة الأولى. وعلى هذا يميزون:
الصراعات بين الدول (يتم تمثيل كلا الجانبين المتعارضين من قبل الدول أو تحالفاتها) ؛
حروب التحرير الوطنية (أحد الأطراف تمثله الدولة): مناهضة الاستعمار ، حروب الشعوب ، ضد العنصرية ، وكذلك ضد الحكومات التي تتعارض مع مبادئ الديمقراطية ؛
نزاعات داخلية مدولة (تعمل الدولة كمساعد لأحد الأطراف في نزاع داخلي على أراضي دولة أخرى).
_________________________________________________________________________________
تم تكريس الدراسة التي كتبها ن. آي دورونينا ، وأعمال ل.
في الغرب ، في نفس الوقت تقريبًا ، تم تطوير مفهوم "إستراتيجية إدارة الصراع" ومفهوم "إستراتيجية الحد من تصعيد النزاع" ، والتي حظيت بتداول واسع إلى حد ما.
في السنوات التي أعقبت نهاية الحرب الباردة ، لم يضعف الاهتمام بمشاكل النزاعات الدولية. كانت هناك (ولا تزال) أسبابًا وجيهة لذلك. خلقت تصفية الاتحاد السوفياتي وضعاً جيوسياسياً جديداً ومعقداً للغاية ، لم تفشل العديد من الدول في كل من الغرب والشرق في الاستفادة منه لمصالحها الخاصة. على وجه الخصوص ، أصبحت محاولاتهم لتضمين جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة في مجال نفوذهم ، والتي كانت العلاقات بينها صعبة أيضًا (خاصةً بعضها مع روسيا) ، أكثر نشاطًا. الصراعات المحلية في الشرق الأوسط لا تتوقف ، إلخ.
السمة المميزةالبحث في التسعينيات هو أنها أصبحت معقدة بشكل متزايد ومتعددة التخصصات بطبيعتها. يتم إعطاء مكانة مهمة لمحاولات التنبؤ بالنزاعات الدولية ومنعها.
لا تستنفد الأحكام والاستنتاجات الواردة أعلاه المجموعة الكاملة من الأسس والمعايير لتصنيف النزاعات ، ولكنها تعطي صورة كاملة إلى حد ما عن الأساليب الممكنة في هذا الصدد.
أنواع الصراعات السياسية: هناك العديد من أنواع النزاعات المختلفة ، وهنا نوعان من أشهرها:
تحدد كاثرين بارنز (معهد تحليل النزاعات وحلها ، لندن) الأنواع التالية من الصراعات السياسية المعاصرة الموجودة في العصر الحديث. علاقات اجتماعية:
· النزاعات الداخلية (1. النزاعات القانونية بين الدولة. الناشئة في نظام سلطة الدولة نفسه) على سبيل المثال: سير العمل القديم وظهور مؤسسات الدولة الجديدة ، نطاق سلطاتها ، موارد السلطة ؛ 2. صراعات المكانة والدور (التوزيع غير المتكافئ للسلطة ، الحقوق ، الحريات ؛ 3. الاختلافات في الثقافة السياسية (أساليب التفكير السياسي ، الاختلافات في تصور الواقع ، أفعال كبيرة مجموعات اجتماعية)
الحروب الصغيرة (النزاعات المحلية) ؛
الصراعات في دول ما بعد الاستعمار ؛
· النزاعات العرقية.
الصراعات على الموارد (الاقتصادية ، والجمارك ، والتجارة) ؛
· الصراعات في الدول المتفتتة.
أزمات سياسية معقدة
• الكوارث الإنسانية.
· "حروب جديدة" (تعريفها من قبل الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش).
1. تضارب المصالح - يسود في الدول المتقدمة اقتصاديًا والدول المستقرة. القاعدة السياسية هي "المساومة" حول تقسيم الاقتصادي. بيروغ. يمكنك دائمًا إيجاد حل وسط
2. تضارب القيم هو سمة من سمات الدول النامية مع نظام دولة غير مستقر. تتطلب المزيد من الجهد لحلها. أصعب لتقديم تنازلات
3. صراع الهوية - سمة من سمات المجتمعات التي يوجد فيها تماهي مع مجموعة معينة (عرقية ، دينية) ، وليس مع المجتمع ككل.
نظرية احتياجات الإنسان: معظم ممثل مشهور J. Burton (لن تعمل CONFLICTOLOGY_MASLOW !!). وفقًا لبيرتون ، يؤدي الفشل في تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية إلى الصراع. إنه يفهم الحاجة على أنها غرائز عميقة (الحاجة إلى الهوية والغذاء والأمن). لا يمكن أن تقول لفلسطيني "انسى هويتك" لأن هذا هو الدافع الرئيسي له للمشاركة في الصراع. في رأيه ، تنشأ الخلافات عندما تحرمك الهياكل الاجتماعية من الهوية (مثال على الصراعات مع الأقليات القومية). غالبًا لا يمكن المساومة على الهوية ، ووفقًا لبورتون ، فإن هذه الصراعات معقدة وعميقة الجذور. يعتقد بيرتون أنه يمكن حلها. على سبيل المثال ، في فرنسا ، من المهم أن يرتدي المسلمون الحجاب لتحديد هويتهم. المراهقون الأمريكيون يظهرون هويتهم في هجمات المشاغبين في الشوارع (حركة الهيبيز ، الكتابة على الجدران). يعتقد بيرتون أنه يجب تلبية الاحتياجات الأساسية للإنسان معًا ، بالتزامن. كما طور نظامًا للحكومة الملتزمة بالقانون واقترح عملية يسميها عملية صنع القرار. الطريقة الوحيدة هي عندما يتمكن الشخص من تلبية احتياجاته الإنسانية - عندها فقط لن تكون هناك صراعات اجتماعية. إن فكرة الحاجات الإنسانية الأساسية لا تفترض مسبقًا سلطة الدولة القوية وتأثيرها ، بل تفترض مجتمعًا مدنيًا متطورًا. جادل بيرتون بأن الاحتياجات الإنسانية الأساسية هي أصل النزاعات ، وأن المؤسسات الاجتماعية الأساسية التي تقمع الاحتياجات تخدم الصراع ، وأنه من أجل تجنب العنف ، يجب أن يأتي العامل البشري أولاً في استراتيجيات هذه المؤسسات.
نظرية حل النزاع (حل النزاع) جي بيرتون ، ك.ميتشل:
في إطار تخصصات العلوم السياسية الحديثة ، هناك العديد من المجالات والمدارس التي تدرس النزاعات وتبحث عنها وتتنبأ بها. نحن نفرد ثلاثة منها فقط - هذه دراسة الصراع من وجهة نظر المدارس "السياسة الحقيقية" ، "السياسة المثالية" و "دراسة حل النزاع".
"سياسي حقيقي" - يعتبر الصراع صراع مصالح. المؤيدون الرئيسيون هم ممثلو الواقعية الكلاسيكية. وفقًا للواقعية الكلاسيكية ، فإن العلاقات الدولية هي صراع على السلطة والعسكرية والاقتصادية وأي صراع آخر ، يتم خوضه من أجل الثروة والهيبة والنفوذ. تشرح هذه المدرسة وجود أي صراع وحتميته على وجه التحديد من خلال مصالح الأطراف ، والتي ، على سبيل المثال ، لا يمكن للدولة إلا أن تسعى وراءها ، لأنها تحدد إلى حد كبير المساحة السياسية والجيوسياسية والجغرافية الاقتصادية للبلد. دعم المصالح إلى حد ما بالقوة ، أي القدرة على ممارسة الضغط (سياسي ، اقتصادي في كثير من الأحيان) على الجانب الآخر ، وهي المهيمن الرئيسي لعلاقات الصراع. في الصراع ، وفي السياسة بشكل عام ، كما يعتقد الواقعيون ، يجب على كل مجتمع أن يعتمد على قوته الخاصة ومكره ، والتي يسمونها غريزة الحفاظ على الذات. تشير الجغرافيا السياسية الحديثة إلى عدة أنواع من الواقعيين.
الواقعيون المتطرفون - أتباع ميكافيللي أو هوبز - هم معارضون للتسوية ، ويعتقدون أن الصراع أمر لا مفر منه ، وهم يلتزمون بفكرة تدمير العدو ، ويتعاملون مع الحرب ببساطة على أنها وسيلة أخرى للسياسة. في عام 1917 ، تمسك مؤسس الاتحاد السوفياتي ، لينين ، أيضًا بموقف الواقعية المتطرفة. لقد أيد جميع الإجراءات التي تهدف إلى دكتاتورية الطبقة العاملة على نطاق عالمي.
الواقعيون المعتدلون ليسوا راديكاليين للغاية ، فهم يحاولون إيجاد حل وسط ويأملون في تجنب الحرب. منذ الحرب العالمية الثانية ، كانت الولايات المتحدة ، على سبيل المثال ، يحكمها الواقعيون المعتدلون. وهكذا ، في 1946-1947 ، طور كينان استراتيجية معروفة لاحتواء التوسع السوفيتي بمساعدة التدابير الاقتصادية والسياسية والعسكرية للولايات المتحدة وشركائها. يمكن أيضًا اعتبار Spykman و Neubuhr و Morgenthau من الواقعيين المعتدلين ، الذين جمعوا ووصفوا البديهيات الست للواقعية:
1. الطبيعة البشرية: الشخص جشع وعدواني في كثير من الأحيان.
2. الآن الدولة هي الفاعل الرئيسي في السياسة العالمية. الأمم المتحدة أداة في يد كل دولة.
3. السلطة والمصلحة: المصلحة الأساسية لكل دولة هي زيادة سلطتها. السياسة هي صراع على السلطة. على أراضيها ، تبني الدول قوات عسكرية واقتصاديات ، وخارجها تدخل في تحالفات ضد الآخرين.
4. العقلانية: تنظر الدولة في الكيفية التي يكون من الأفضل بها تعظيم سلطة الدولة.
5. الفجور: لا توجد مدونة أخلاقية مشتركة بين الدول. أخلاق كل عمل لا يتجاوز حدوده. كما كتب مورغنثاو ، "يرفض الواقعيون الاعتراف بالتطلعات الأخلاقية للأمة الفردية التي تحكم قوانينها الأخلاقية الكون".
6. التاريخ والعلوم: دراسة متعمقة للتاريخ - أفضل طريقةفهم جوهر العلاقات الدولية ، والنماذج العلمية والإحصاءات لا يمكن أن تحدد حيوية السياسة.